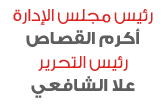"أوضاع العالم 2015.. الحروب الجديدة" كتاب صدر عن دار مؤسسة الفكر العربى فى بيروت لتقرير أوضاع العالم 2015 ميلادية، ترجمة نصير مروّة، والذى يحرره كل من المفكرين الفرنسيين برتران بادى ودومينيك فيدال.
فمنذ انطلاقته فى العام 1981 و"أوضاع العالم" يتقصى ويواكب الطفرات التى يشهدها العالم. وشبكة مؤلفيه تستند على مجموعات بحث وباحثين كُثُر فى فرنسا والخارج، وفى الميادين كافة التى تتعلق بما هو دولى.
القسم الأول من الكتاب "أوضاع العالم 2015.. الحروب الجديدة" يعتمد من وجهة نظر إجمالية جامعة لدراسة تحولات الحرب أو استحالتها (كما يقال فى العلوم الطبيعية)؛ أما القسم الثانى فيدرس أشكال النزاعات المعاصرة وصورها والفاعلين فيها، عبر دراسة عدد من الحالات المختلفة. وكما فى كل عام، فإن القسم الثالث يتكون من مقالات "جهوية" أو "إقليمية" تُسلط الضوء على التوترات الاستراتيجية والدبلوماسية العظمى، للكشف عن تطور النزاعات فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
دفتر خرائط وملحقات التقرير الإحصائية: وهى من أجل مساعدة القرّاء على رؤية ديناميات النزاعات المعاصرة، استعان فريق أوضاع العالم بالجغرافى وواضع الخرائط والصحافى فيليب ريكازفيتش الذى يجد القراء عمله ماثلاً فى الدفتر الخرائطى وفى الملحقات الإحصائية المكملة لهذا التقرير.
نرى برتران بادى يتحدث باستفاضة فى التقرير تحت عنوان "الحرب بين الأمس واليوم" عن ظاهرة المجتمع الاحترابى، والذى يظهر عبر الزمن والديمومة، وضرب عدة أمثلة على هذا النموذج مثل الكونغو الديمقراطية التى تعيش فى الاحتراب منذ خمسين سنة متتالية من دون انقطاع تقريبًا، وأفغانستان منذ خمس وثلاثين سنة، والصومال منذ ما يقارب الخمس والعشرين، فى حين أن تشاد والسودان واليمن دخلت هذه الوضعية، من دون أن تشهد دائمًا الحدة نفسها، منذ ستينيات القرن الماضى، بينما تبدو سوريا والعراق وكأنهما دخلا فيها برفقة جمهورية أفريقيا الوسطى. أو بعبارة أخرى فإن مجتمع الاحتراب يتحقق على نحو مؤكد إلى هذا الحد أو ذاك، فى نظم سياسية لم تستطع أن تبنى عقدًا اجتماعيًا حقيقيًا؛ نظم حجم السياسة إلى مستوى الإكراه، وقلصتها إلى حدود القسر البدائى أو الابتدائى، وإلى منسوب العلاقات الزبائنية التى تستبعد وتستثنى بأكثر مما تدمج وتوحد وتكمل. وكل هذا وفق غرار يجعل جميع الحائزين على السلطان من ممثلين وفاعلين محليين وقوى خارجية، يجدون مصلحتهم على المدى القصير فى إفلاس السياسة المزمن.
إن غياب سلطة الدولة ومرجعيتها يشحذ المطامع الخارجية ويزيد من حدتها: اليورانيوم فى النيجر، الماس فى سيراليون، والمعادن النادرة والثمينة فى الكونغو، أمور تغدو جميعها رهانات تُظهِر للعلن دور النهب الذى تتولاه الشركات الأجنبية، التى هى متعددة الجنسيات، وتبرزه بالقدر الذى يكفى لكى يتخذ الفقر المحلى دلالة عالمية. ولهذه الوصاية الاقتصادية صداها على الصعيد السياسي: فشبهُ الدولة المحلية، السلطوية، شبهُ الموروثة، التى هى المرمى البديهى الذى تصوب إليه المجتمعات، ليس لها من وجود إلا فى الصلة الزبائنية والعلاقة التلجيئية التى غالبًا ما تربطها بالدولة التى كانت تستعمرها. وعلى هذا، فإن مستقبل المجتمعات الاحترابية هذه، يلتقى بالمصلحة القومية لتلك الدول، ويحفز من ثم مصالح نظيراتها ونظرائها ويشحذ هممهم.
وفى الحين نفسه، فإن الدولة المنهارة – أو التى أنهكها مرضها – تجد نفسها فى جوار دول أقوى منها لا تستبقى على سبقها وغلبتها إلا بإظهار مطامعها فى المجتمعات الاحترابية. فهذا هو وضع باكستان إزاء أفغانستان، وكينيا أو أثيوبيا إزاء الصومال، ونيجيريا فى أفريقيا الغربية، ورواندا أو أوغندا إزاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمملكة العربية السعودية إزاء اليمن، وحتى تشاد، ولو على نحو نسبي، إزاء أفريقيا الوسطى؛ وكل هذا مؤتلفًا مع عصبيات قديمة عرقية أو دينية: فالأمر لا يحتاج لأكثر من هذا من أجل تدويل مجتمعات الاحتراب.
فى حين أن الحرب الكلاسيكية كانت ضربًا من وضع المجتمع تحت الوصاية السياسية، فإن الحروب الجديدة لا تعنى اندماج السياسى بالاجتماعي. المجتمع الاحترابى يتغلغل فى حميمية الحياة اليومية لكل فرد، من دون أن يكون ثمة نظام سياسى يغلب عليه ويسيطر فيه.
ونحن واجدون من جهة أولى، كافة العلاقات منحلة فى الأوليات "الميكانيزمات" الحربية، وواجدون كل فرد معرّضًا لحياة الاحتراب، كمقاتل، وكمرمى، وكضحية، عبر الموت، والإصابة بجروح، والمرض، والألم، والمعاناة، والنزوح أو التهجير الذى يتحول إلى ظاهرة اجتماعية كبرى تعيد إنتاج عالم المجتمعات الاحترابية المصغر، عبر كل معسكر أو كل طرف من الأطراف.
فيما يقدم رازميغ كوشيان الأستاذ بجامعة السوربون قراءته حول ساحات المعارك الجديدة، مركزًا على البيئة ومشاكلها، حيث يأخذ العسكريين التغير المناخى على محمل الجد. فكيف تراهم ينظرون إلى العلاقة بين الأزمة البيئوية وبين خوض غمار الحرب؟ تكاثر الكوارث الطبيعية يتضمن بادئًا أنه سيُطلب إلى الجيوش أن تأتى لمساعدة الأهالي، و"إحلال السلام" فى آن واحد. وثمة حدثان يشهدان على هذا التفاعل المتزايد بين الشواغل البيئوية والشواغل الأمنية: تسونامى عام 2004 فى المحيط الهندي، إعصار كاترينا عام 2005 فى نيو أورلينز فى الولايات المتحدة. ففى كلتا الحالتين لعب الجيش دورًا مهما فى إدارة كلتا المأساتين، وذلك بتوصيل المعونة إلى الضحايا مثلا، أو بالحفاظ على الأمن والنظام فى سياق كانت بقية هيئات الدولة فيها متوقفة عن العمل وغير قادرة عليه.
ويوشك التغير المناخى فى نظر العسكريين، أن يُضعف بعض الدول التى هى ضعيفة أصلاً، وحساسة استراتيجيًا. والمقصود هنا هو الدول الفاشلة الشهيرة failed states التى نظر لها البنتاجون منذ إدارتى جورج بوش الأب وبيل كلينتون. والمعنى بهذا التوصيف، هو دول يفترض أنها عاجزة عن تأمين الوظائف "الطبيعية" لدولة ديمقراطية حديثة: الأمن، العادلة، النمو، المساواة أمام القانون ...إلخ.
وعلى هذا فإن انشغال العسكريين بالتغير المناخى هو أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمقياس الاستراتيجى الغالب لفترة ما بعد الحرب الباردة: الصراع ضد الإرهاب. والقراءة التى تجريها الجيوش لهذه الظاهرة، هى قراءة محددة بتحديد تدخل فيه عوامل عديدة، أى بتحديد تضافرى يلعب فيه أساسا شاغلهم الرئيسى الذى كان قائمًا منذ قبل 11 سبتمبر 2001، ثم تعاظم بعد ذلك.
لكن ثمة رابط ثانٍ يربط الإرهاب بالأزمة البيئوية: وهو أن الأزمة تقدّم للإرهاب أرضًا يزدهر فيها، وبخاصة فى الدول الفاشلة. وعلى هذا، فإن التغير المناخى والصراع ضد الإرهاب، يمثلان ظاهرتين يتعقلهما العسكريون مجتمعين معًا.
وكثيرًا ما تقدّم الكتابات الذائعة حول هذا الموضوع، اللاجئين المناخيين الذين يقدر عددهم حاليًا ب25 مليونًا، على أنهم "الحلقة المفقودة" التى تصل الأزمة البيئوية بالتوترات السياسة التى يمكن أن تنتج عنها. فتعريف اللاجئ المناخى هو أنه شخص يرتبط قراره بالهجرة بعوامل بيئوية، ولو على نحو جزئى فى أقل تقدير. ووفقًا لهذا التفكير، فإن الأزمة البيئوية تنتج لاجئين تزعزع هجراتهم المناطق التى يستقرون فيها؛ وقد ينتج عن ذلك نزاعات.
خالد عزب يكتب: مذكرات السلطان عبد الحميد وكاتب سيرته.. رؤية تاريخية

-
لجان امتحانات الثانوية العامة تستقبل أسئلة امتحان اللغة العربية
-
علي فرج يتأهل لمواجهة مصطفى عسل نهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش
-
نور الشربيني تتأهل لمواجهة نوران جوهر في نهائي بطولة الأبطال للإسكواش
-
مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة العظماء الثمانية للإسكواش
-
التعادل السلبى يحسم قمة هولندا ضد فرنسا فى يورو 2024
-
جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلي والزمالك اليوم الجمعة
-
كولر: عدم لعب الزمالك للقمة لا يعنينى.. وهذا سبب استبعاد الشناوى
-
قوات الاحتلال تنسف عددا من المنازل فى حى البرازيل جنوبى رفح الفلسطينية
-
خلاصة دروس اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة وأسئلة مهمة لن يخرج عنها الامتحان
-
إصابة عريس و3 أطفال ونجاة العروس إثر حادث تصادم سيارة الزفة بالغربية