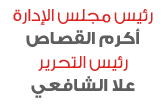هنا كلام خطير وصادم أراه حقا، فمن انزعج منه فليعرضه على عالم متخصص ثقةٍ؛ ليبين خطأى فأتوبَ منه وأقبِّلَ شاكرا يدَيْهِ وقدمَيْهِ وبين عيْنيْه.
إنها مصطلحات متعددة المعانى، قبولها مطلقا خطأ ورفضها مطلقا خطأ، والصواب أن يقبل من معانيها ما كان حقا ويرفض ما كان باطلا.
لا يتناقض الإسلام مع الديمقراطية إن كانت تعنى حق الشعب فى أن يحكم نفسه بما يختار من قوانين، دون إقصاء لأى خيار يختاره ومن خياراته حقه أو حق أغلبيته فى أن تستلهم شريعة دينها فى صياغة دستورها وقوانينها، صياغة تراعى خصوصيات الأقليات وتحترم مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد.
كما لا يتناقض الإسلام مع العلمانية إن كان هدفها التحررَ من سلطة رجال دين يزعمون لأنفسهم العصمة من الخطأ والتسليمَ لسلطة الشعب والحيادَ بين المتدينين وغير المتدينين وعدمَ معاداة أى متدين وعدمَ الانحياز إلى أى متدين ضد أى متدين، أى عدم التمييز بسبب الدين بين المواطنين فى حقوق المواطنة وبين الناس فى الحقوق الإنسانية، ولم يكن هدفها إعاقة إرادة الأغلبية الشعبية فى أن تستلهم شريعة دينها فى صياغة دستورها وقوانينها صياغة تراعى خصوصيات الأقليات وتحترم مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد. وفى السياق نفسه لا يتناقض الإسلام مع إعلان رئيس الوزراء التركى أردوغان أنه مسلم بصفته الشخصية علمانى بصفته رئيسا للوزراء، إن كانت علمانيته بصفته رئيسا للوزراء لا تعوق حق الشعب التركى فى أن يستلهم شريعة دينه فى صياغة دستوره وقوانينه، صياغة تراعى خصوصيات الأقليات وتحترم مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد.
كما لا يتناقض الإسلام مع الليبرالية ومعناها فى العربية مأخوذ من معنى الحرية إن كانت لا تزدرى هوية المجتمع ولا تنتهك نظامه العام ولا تتبنى حرية إشاعةِ الشذوذِ الجنسى وفواحش الزنى والسحاقِ وقومِ لوط فى مجتمعنا.
إن كانت الديمقراطية والعلمانية والليبرالية كذلك فلا تناقض بينها وبين جوهر الإسلام، وإنما التناقض بين فهم وممارسات الديمقراطيين والعلمانيين والليبراليين الخارجين على جوهر هذه المعانى للديمقراطية والعلمانية والليبرالية، وبين فهم وممارسات الإسلاميين الجاهلين بجوهر الإسلام ومعانى الديمقراطية والعلمانية والليبرالية عند القائلين بها فى مصر، بل إن كانت الديمقراطية والعلمانية والليبرالية كذلك فإن الإسلام ديمقراطى علمانى ليبرالى، قبل أن يعرف العرب ألفاظ الديمقراطية والعلمانية والليبرالية، وقبل أن يمارس الديمقراطيون معنى الديمقراطية والعلمانيون معنى العلمانية والليبراليون معنى الليبرالية، وبيان كل ذلك ما يلى:
أولا: الديمقراطية قيمة محايدة لا علاقة لها بكفر ولا بإيمان
-1 فهى أشبه بالقارورة يملؤها خمرا من يشاء ويملؤها عسلا من يشاء، فالشعب الذى يحكم نفسه بما يختار وفقا للديمقراطية ويجعل اختياره قوانين يضعها على هواه هو كالذى يملأ القارورة خمرا، والشعب الذى يحكم نفسه بما يختار وفقا للديمقراطية ويجعل اختياره قوانين شريعته التى يدين بها لخالقه هو كالذى يملأ القارورة عسلا.
-2 وآلة الديمقراطية صناديق اقتراع، وهى بطبيعة الحال ستكون مع الأغلبية، وستكون فى مصر مع المسلمين لأنهم فيها أغلبية لا لأنهم مسلمون، ولن تكون فى فرنسا مع المسلمين لأنهم فيها أقلية لا لأنهم مسلمون، وإن صار النصارى فى مصر أغلبية صار لهم من الحق ما للأغلبية وصار من حقهم أن تحكم شريعتهم الأقلية المسلمة فى الشأن العام، بشرط عدم انتهاك مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد.
-3 وإذا كان النص القرآنى (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ «06/الأنعام57») يجعل الله حاكما باعتبار أنه مصدر الحكم، وكان النص القرآنى (أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ «04/النساء58») يجعل الناس حكاما باعتبار أنهم المنفذون لحكم الله، فكذلك قولنا (إن الحكم إلا للشعب) يجعل الشعب المسلم حاكما باعتبار أنه المختار لحكم الله والمنفذ له.
ثانيا: الديمقراطية تتوافق مع مبدأ الشورى القرآنى (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ «الشورى38»)، (وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ «آل عمران159») كما يلى:
إن الأمر بالشورى لا يتعلق بالأحكام المنصوص عليها، فليس هو أمرا بالشورى فى سارق أيقطع أم لا، أو قاتل متعمد أيقتص منه أم لا، بل هو يتعلق بما لا نص فيه من أمور اجتهادية بشرية فى سياسة المجتمع. والاستشارة والمشار به ملزمان للحاكم إن كان المشيرون نوابا منتخبين من الشعب؛ لأنه يحكم بما يختاره الشعب وبالتالى بما يختاره نوابه لا بما يختاره هو كما سيأتى، وإن انقسمت آراء المشيرين فما يشير به أغلبيتهم أما النبى صلى الله عليه وسلم فالاستشارة ملزمة له لأنه مأمور بها، وأما ما يشار به عليه فملزم له فيما لو أخطأ فاستشار فأشير عليه بصواب، بخلاف ما لو أخطأ فاستشار فأشير عليه بخطأ أو صواب ثم رأى بعد المشورة صوابا أو أصوب بنفسه أو بالوحى الذى يصحح له دوما دون غيره، فهو ليس كغيره صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: الشعب له الحق فى أن يُحكَم بما يختار من قوانين، هذا هو الديمقراطية، وهو الإسلام أيضا، وكما يلى:
أ- نص القرآن (لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ «02/البقرة256») وسائر نصوصه فى معناه، معناه أنه لا يجوز لأى أحد أن يكره أى أحد أن يعتنق دينا ما أو أن يلتزم بشرعة دين ما، فالنفى هنا نهى وهو مطلق فهو يشمل كل أحد، والدين هنا مطلق فهو يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وفعل الجوارح معا هذا هو معنى الآية واضحا، فلا يجوز لملك أو سلطان أو أمير أو رئيس دولة أن يكره شعبه على أن يعتنق دينا ما أو أن يلتزم بتشريعات دين ما.
وهذا معناه أن كل إنسان حر فى كل ما يخصه ولا يحكمه إلا قانون يختاره لنفسه، وأن كل جماعة أحرار فى كل ما يشملهم ويخصهم يحكمهم قانون يختارونه لأنفسهم بالتراضى بينهم لا قانون يفرضه عليهم رئيس أو ملك أو أمير، وهذا عين ما تعنيه الديمقراطية بإعلانها أن السلطة للشعب وأن الشعب هو السيد. ثم إن كان الشعب مسلما فإنه سوف يختار شريعة دينه، فيصل الإسلام إلى الحكم بالديمقراطية، فتكون الديمقراطية وسيلة بل ضمانة لحكم المسلمين لأنفسهم بشريعتهم لا معوقا لهم، ويكون دليلَ مشروعيتها هو (لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ «البقرة 256») وسائرُ نصوص القرآن فى معناه، وهذا ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم حين طلب من المؤمنين بيعته أميرا عليهم باستفتاء طوعى تحت الشجرة، فالدخول فى الدين كله استفتاء طوعى فيكون الدخول فى بعضه وفيما يترتب عليه طوعيا كذلك، ولو لم تكن بيعته صلى الله عليه وسلم استفتاء طوعيا بإرادتهم الحرة لكان طلبها تحصيل حاصل وهو عبث ولمَا طلبها صلى الله عليه وسلم بل أمر بها كما أمر الله السماوات والأرض (اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً «فصلت 11») ولو كان إتيانهما استفتاء طوعيا لقال لهما ألا تأتيان؟
أمّا أنه لم يقع فى عهده انتخاب فلأنه لم يكن فى المؤمنين من يعتقد أن هناك من هو مثله صلى الله عليه وسلم، بله أن يكون أصلح منه بأبى هو وأمى، ولكن جاء الانتخاب بعد وفاة النبى للصديق رضى الله عنه فى سقيفة بنى ساعدة، ثم بعد وفاة الفاروق رضى الله عنه بترشيح ستة اختار الناس أحدهم وحكم كل حاكم منهم بين الناس بالشريعة التى ارتضوها طوعيا قبل أن ينتخبوه، وانتخبوه على شرط أن يحكم بينهم بها، وهذا هو عين الديمقراطية.
ولا يفرض الإسلام تشريعا بالقوة إلا ما يفرض عقوبة دنيوية على مخالفته، ولا يفرضه إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه كما تبين آنفا ولا يفرضه على الأقلية حتى وإن اختارته الأغلبية إلا إذا تعلق بالشأن العام لما سيأتى، وما يفرضه بالقوة غايته حماية حقوق العباد لا حق المعبود كغاية أى قانون فى أى دولة فى أى زمان أو مكان، وهو عقوبات القتل والحرابة والجرح والسرقة والربا والقذف وفواحش الزنى والسحاق وقوم لوط.
ب - الشأن شأنان: خاص يخص كل مجموعة أو طائفة، وعام يشترك فيه جميع المجموعات والطوائف التى يظلها سقف الوطن الواحد.
-1 فأن يشرب الخمرَ مسلمٌ أو يبيع مسلمٌ لمسلمٍ أو يسرقه أو يقتله أو يتزوج مسلم بمسلمة أو يزنى بها أو تأتى مسلمات فاحشة السحاق أو يأتى مسلمان فعل قوم لوط كلُّ ذلك شأن يخص المسلمين، ويحق لهم الاحتكام فيه إلى شريعتهم دون حق لمن سواهم فى الاعتراض عليهم وأن يشرب الخمرَ نصرانيٌّ أو يبيع نصرانى لنصرانى أو يسرقه أو يقتله أو يتزوج نصرانى بنصرانية أو يزنى بها أو تأتى نصرانيات فاحشة السحاق أو يأتى نصرانيان فعل قوم لوط، كلُّ ذلك شأن يخص النصارى ويحق لهم الاحتكام فيه إلى شريعتهم دون حق لمن سواهم فى الاعتراض عليهم بنص القرآن (فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ «المائدة 42») أى فإن حكموك بينهم، والمعنى من مفهوم المخالفة للشرط هو فإن لم يحكموك فلا تحكم.
-2 أما أن يبيع مسلم لنصرانى أو يسرقه أو يقتله أو أن يبيع نصرانى لمسلم أو يسرقه أو يقتله أو أن تمارس السحاقَ مٌسلمة مع نصرانية أو أن يأتى فعلَ قوم لوط مسلمٌ مع نصرانى، فكل ذلك شأن عام لا بد فيه من توحيد التشريع إعمالا للعدالة، لأنه مثلا لو اختار المسلمون القتل عقوبة للقتل، بينما اختار النصارى التوبيخ فقط عقوبة للقتل، فإنه إن قتل مسلمٌ نصرانيا سيقتل بينما إن قتل نصرانىٌّ مسلما سيوُبَّخ فقط، وهذا ظلم يعرض المسلمين للإبادة على يد النصارى دون رادع؛ إذ التوبيخ ليس رادعا، وهذا مثال غير واقع، فالنصارى لا يوبخون القاتل فقط؛ لكن قصدت به ضرب المثل واضحا لتوضيح الظلم الذى سيقع على إحدى الطائفتين لو ترك لكل طائفة تحديد عقوبة من يجنى من أتباعها على آخر من أتباع طائفة أخرى.
-3 ففى الشأن العام إذن لا بد من توحيد العقوبات إعمالا للعدالة وصيانة لها، فإما العقوبات المختارة من قبل الأقلية وإما العقوبات المختارة من قبل الأغلبية، ثم الحَكَم فى تحديد الطائفة صاحبة الحق فى فرض العقوبة الموحَّدة هو الديمقراطية، بدليل ما ذكرنا سابقا وما سنذكره لاحقا.
ج - ماذا لو فرضت الأغلبية فى الشأن العام قانونا تراه الأقلية ظلما لها وإجحافا بحقها؟
لنكن صرحاء ولنقل: ماذا لو أرادت الأغلبية المسلمة فى مصر فرض الجزية المذكورة فى القرآن الكريم على الأقلية النصرانية المسالمة؟
الجواب على هذا ومثله هو مناقشة جدليات مصطلحات المدنية والدينية أو الدولة المدنية والدولة الدينية، والكلام فى كل ذلك كما يلى.
د - الدولة المدنية والدولة الدينية مصطلحان لا حقيقتان لغويتان ولا مشاحة فى الاصطلاح
-1 والتناقض بين هذين المصطلحين يتمثل فى عنصرين جوهريين يوجدان فى إحدى هاتين الدولتين وينعدمان فى الأخرى والعنصران هما:
- حرية الاعتقاد التى تعنى حق كل أحد فى اعتقاد ما يشاء وفى الدعوة إلى ما يعتقد وفى الردة عما يعتقد.
- والمساواة التى تعنى عدم التمييز بسبب الدين بين المواطنين فى حقوق المواطنة وبين الناس فى الحقوق الإنسانية.
-2 وإن وجد هذان العنصران فى الدولة الدينية انعدم الفرق بين الدولتين، وصار عبثا التنازع على المصطلحين.
-3 وهذان العنصران منعدمان كما سيأتى فى الدولة اليهودية لاحتفال العهد القديم بالعنصرية وبمناهضة من ليس يهوديا وبدعوى أن اليهود شعب الله المختار وأنهم ليس عليهم فيمن سواهم سبيل، ومنعدمان أيضا فى الدولة النصرانية لأن شريعة النصارى هى شريعة اليهود شريعة العهد القديم، ومنعدمان أيضا فى الدولة الإسلامية الأموية وما تلاها من دول سواء السنية والشيعية.
-4 وما الفظائع اليهودية الموحية بقصة تاجر البندقية أمس، ولا الفظائع اليهودية ضد الشعب الفلسطينى اليوم، ولا فظائع محاكم التفتيش النصرانية فى أوروبا أمس، ولا فظائع الحجاج بن يوسف الثقفى السنى أمس، ولا فظائع عون إيران الشيعى وحزب الله الشيعى للنظام السورى الشيعى فى سحق شعبه السنى اليوم، ما كل تلك الفظائع بخافية على أحد.
-5 أما الدولة الإسلامية المحمدية فمتأصل فيها هذان العنصران، ولو تحررت كل من الشريعة الإسلامية السنية والشريعة الإسلامية الشيعية مما أصابها من تحريف لتوافقت كل منهما مع الأخرى ولتوافقتا كلتاهما معا مع الشريعة الإسلامية المحمدية، حيث لا نص قرآنياً ولا حديث محمديا ينتهك حرية الاعتقاد ولا مبدأ المساواة كما سيأتى.
هـ - المدنية والدينية مصطلحان نختلف فى تعريفيهما أو نتفق؛ لكنهما فرع عن أصل
ومن الأصل سأنطلق؛ لأن بالفرع إبهاما أو تعميما قد يجعل البعض يؤذن فى واد غير الذى يؤذن فيه البعض الآخر، فيصير الحوار حوار طرشان، أو قد يجعل الأغلبية تتوهم أن الأقلية تريد أن تحرمها من استلهام قيم دينها فى حياتها، فلتكن دندنتنا حول الأصل.
-1 وفقا للديمقراطية يحق لكل طائفة اختيار قانون خاص ليحكم شأنها الخاص، ووفقا للديمقراطية أيضا يحق للأغلبية اختيار قانون عام ليحكم الشأن العام، بشرط ألا ينتهك حقوق الأقليات، فلا ينتهك حرية الاعتقاد ومبدأ المساواة، فلا يكره فى الدين أحدا، ولا يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون، وبهذا يتحقق للأقلية حقها، ولا فرق عندها حالئذ بين أن تكون الأغلبية قد ابتكرته من بنات أفكارها أو استلهمته من قيم دينها، ولا يحق لها إذن أن تفرض على الأغلبية مرجعية ما، ولا أن تمنعها من استلهام ما تختار من مرجعية.
-2 ومن هنا يحق للأغلبية المسلمة فى مصر أن تنص فى الدستور على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بل أن تنص فيه على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع بشرط ألا تنتهك حق المساواة وحرية الاعتقاد إن كان فيها ما هو كذلك.
-3 وهذا معناه أنه لا يجوز للأغلبية المسلمة أن تفرض جزية على الأقلية النصرانية المسالمة، ولا أن تفرض عقوبة على من ارتد عن ملته ولا أن تمنع نصرانيا من الترشح فى الانتخابات لأى منصب حتى مناصب الولاية العامة، ولا أن تميز بين مسلم ونصرانى فتقتل النصرانى إن قتل مسلما بينما تمتنع عن قتل المسلم إن قتل نصرانيا... إلخ، وكل هذا فى الحقيقة لا يتناقض مع الإسلام الحقيقى، كما تبين آنفا، وكما سيتبين لاحقا.
و- أما جدلية الدين والسياسة أو رجال الدين ورجال السياسة فهى الوجه الآخر لجدلية المدنية والدينية
-1 وكلتاهما تفرعتا من نفس الأصل، فلم يكن الاعتراض على أشخاص رجال الدين بل على ما يحكمون به، ولم يكن الاعتراض على ما يحكمون به لأنه دين؛ بل لأنه كان ينتهك مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد ويفرق بين المواطنين بسبب الدين.
-2 ومن هنا يتبين أنه لا فرق بين أن يحكمنا ساسة ليسوا رجال دين أو أن يحكمنا ساسة هم رجال دين، طالما أن القانون الحاكم يلتزم بالمواصفات والشروط المتفق عليها. والحق عند التدبر أن الحاكم الفعلى فى العصر الحديث هو القانون لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء.
-3 أما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فخادم للشعب يعمل أجيرا لديه مقابل أجر من جيوب دافعى الضرائب بوظيفة مدير للدولة، فهو يحيل إلى مجلس النواب ليشرع وإلى القضاء ليحكم وإلى مجلس الوزراء لينفذ، وهو فى كل ذلك خادم للشعب محكوم به لا حاكم له، فهو محكوم بمجموع الشعب حاكم لأفراده، وحكمه للأفراد لا يكون إلا بعد التفويض من المجموع بالانتخاب.
الشيخ متولى إبراهيم صالح يكتب: الإسلام والديمقراطية والعلمانية والليبرالية.. تناقض أم توافق؟.. الإسلام لا يتناقض مع الديمقراطية إن كانت تعنى حق الشعب فى أن يحكم نفسه بما يختار من قوانين
الإثنين، 27 أغسطس 2012 08:42 ص الشيخ متولى إبراهيم صالح
الشيخ متولى إبراهيم صالح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة