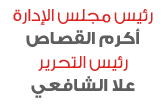لاشك أن سياسة أية دولة تعتمد على مجموعة من العوامل التى يطلق عليها عوامل ثابتة وأخرى متغيرة، فالعوامل الثابتة مثل الموقع الجغرافى، التراث الحضارى، السكان والموارد الطبيعية، وهى بصورة عامة تتسم بالثبات النسبى، أما العوامل المتغيرة فهى تشمل شخصية الزعيم السياسى، النموذج السياسى للدولة، دور القوى السياسية والحزبية، دور المؤسسات التقليدية للدولة: القضاء والقوات المسلحة والشرطة، والنخب السياسية والثقافية.والمجتمع المدنى.
ولسنا بصدد بحث كل تلك العوامل وتأثيرها، ولكننا نبحث فقط فيما يخص "استراتيجية السياسة الخارجية للدولة فى عهد رؤساء مصر الأربعة"، وهم السادات ومبارك مرسى فى مواجهة الاستراتيجيات الكونية والإقليمية فى المنطقة وأثرها على مشروع النهضة المصرية فى الفترة من عام 1952-2013.
وأنا أُدرك أن الرئيس محمد نجيب كان أول رئيس لجمهورية مصر بعد ثورة 1952، ولكنه لم تتح له فرصة بلورة سياسة خارجية مستقلة، كما أُدرك أن الرئيس محمد مرسى رغم أنه لم يبق فى السلطة سوى عام واحد ومع هذا فقد حدث تغير شبه جوهرى فى السياسة الخارجية المصرية.
نتناول فى هذا المقال التغيير والتحديات التى أدت إليه وآثارها فى التعامل، لكى يكون ذلك هاديًا ونبراسًا لاستراتيجية السياسة الخارجية للقيادة المصرية الجديدة أو بالأحرى الرئيس السادس لمصر بعد ثورة 23 يوليو 1952 والأول بعد ثورة 30 يونيه 2013.
ونطرح التساؤل لماذا الحديث عن التحديات الخارجية لمشروع النهضة المصرية فى كل مرحلة؟ أليس ذلك هروبًا من الواقع وبحثًا عن كبش فداء؟ ألا يعبر ذلك عن ضعف داخلى؟ أليست السياسة الخارجية نابعة من أو تابعة للسياسة الداخلية؟
والإجابة السريعة الموجزة هى نعم تؤثر التحديات الخارجية على المشروع النهضوى ويتوقف مدى تأثيرها على ضعف وقوة السياسة والأوضاع الداخلية، وعلى الموقع الاستراتيجى للدولة، وعلى طبيعة النظام السياسى، والقيادة السياسية، ولهذا كان اختيار اسم الموضوع هو "استراتيجية السياسة الخارجية فى مواجهة التحديات الكونية والإقليمية" وأثرها على مشروع النهضة فى مصر من 1952-2013.
لقد واجه جمال عبد الناصر منذ البداية عدة تحديات فى مقدمتها تحدى الوجود الإسرائيلى الذى يهدد أمن مصر، وتحدى القوى الاستعمارية التقليدية، ثم تحدى القوى العالمية الصاعدة ممثلة فى الولايات المتحدة، ولجأ إلى فلسفة التوازن، وإلى ركائز للعمل. تمثلت هذه الركائز فى البعد العربى، البعد الإفريقى، والبعد الإسلامى، بينما فلسفة التوازن اعتمدت على الاتجاه للكتلة الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى والصين وابتكار سياسة جديدة للدول حديثة الاستقلال من خلال إنشاء قوة جديدة وهى حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 بعد ذلك.
واستطاع جمال عبد الناصر أن يحقق الجلاء البريطانى عن مصر بمعاهدة عام 1954 ثم مواجهة العدوان الثلاثى عام 1956 والوحدة مع سوريا 1958.
ولعبت مصر دورًا مهمًا فى تحرير العالمين العربى والأفريقى، ولكنه أخفق فهم وإدراك طبيعة البعد الإقليمى العربى والإسلامى، وعلاقة الحكام مع الشعوب، ومرحلة التطور السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وإدراك طبيعة إسرائيل، وهى استعمارها الاستيطانى بجذوره التاريخية كركيزة فى المنطقة، وطبيعة القوى الصاعدة الجديدة على الساحة الدولية أى الولايات المتحدة، والتى هى مثل أى قوة فى حالة صعودها تكون عنيفة ومتشددة، كما اخفق فى إقامة بنيان داخلى يعزز أفكاره ومشروعه النهضوى لذلك بدأ المشروع فى التراجع مع حدوث الانفصال ثم بالتورط فى اليمن عام 1962 ثم هزيمة 1967 وأخيراً بوفاة عبدالناصر فى سبتمبر 1970.
أما أنور السادات، فقد استطاع القيام بأول حرب شبه متنصرة عام 1973 ونقول شبه منتصرة لأنها لم تحقق النصر الكامل، ولكنها هزمت مفاهيم عسكرية كانت شبه ثابتة مثل مفهوم استراتيجية الحصون " خط بارليف"، وأسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يهزم، ونجح فى توحيد الموقف العربى المؤيد له وفى تحرير معظم سيناء بالعمل السلمى خلال مبادرة السلام وزيارته للقدس والتفاوض. ولكنه اخفق فى بناء اقتصاد مصرى سليم لانتشار الفساد، وأخفق فى بناء نظام مدنى بإطلاق تيار الإسلام السياسى لمواجهة التيار القومى العربى واليسارى، وعجز عن بناء قواعد شعبية حقيقية أو ديمقراطية حقيقية رغم انه أطلق بدايتها فيما اسماه " المنابر" وانفتح على القوى الغربية وعلى القوى الإقليمية. ولكنه أخفق فى الحفاظ على التوازن فى السياسة الخارجية فى الإطار الدولى، وعجز على الحفاظ على البعد الإقليمى، إذا انقسم العرب إلى فريقين، ولم يحقق أى ركيزة افريقية ذات مصداقية إضافة لتراث عبدالناصر.
حسنى مبارك انتهج فلسفة "الثبات فى مواجهة التغير" و" الإصرار على الفساد فى مواجهة الضغوط" لذلك لم يستطيع أن يبلور مشروعا نهضويا قوميا مثل عبد الناصر، ولا مشروع أمن وطنى مثل إنجاز السادات فى حرب أكتوبر، وافتقد رؤية الأول وشجاعته، كما افتقد دهاء الثانى ومناوراته، وتحول إلى أسير لثلاث قوى: أجهزة الأمن ومحدداته فأضعفت علاقاته فى مجتمعه وقواه النشطة، كما أضعفت علاقاته مع أفريقيا بعد محاولة الهجوم الذى تعرض له فى أديس أبابا 1995 ثم تدهورت علاقاته مع أفريقيا، ولم يستطع تطوير مفهوم إسلامى أو مفهوم عربى وإن نجح فى التعامل مع مختلف دوائر السياسة الخارجية دون عمق حقيقي: فعلاقاته العربية كانت سطحية، وعلاقاته الإسلامية محدودة، ومع عدم الانحياز حدث التغير سلبياً وتراجع الدور السياسى لمصر دوليا وإقليميا وتحول فى سياسته مع القوة العظمى " أمريكا "، و"القوة الإقليمية"، "إسرائيل" إلى مجرد الدوران فى فلكها، ثم عجز عن بناء نظام داخلى بالانغماس فى مشروع التوريث وما ارتبط به من فساد وعجز ومحسوبية، ولكن ربما يحمد له حرصه على عدم التورط فى حروب مع إسرائيل أو غيرها مما كان سيزيد مصر ضعفاً وتعرضا أمنياً وربما يعيد احتلال أجزاء منها مجدداً.
محمد مرسى جاء للسلطة نتيجة أربعة عوامل هى: ظروف تاريخية، واعتبارات دولية، وأيديولوجية عقائدية. وضعف وخوف السلطة الانتقالية لتجاوزها عمرها الافتراضى، الأول الظروف التاريخية كانت صدفة طارئة بقيام ثورة 25 يناير 2011 على حين غرة من النظام، الذى بلغ أدناه من الفساد والاهتراء، والأحزاب السياسية الكرتونية، والمعارضة المحدودة التأثير، وما يشبه صعود البركان الشعبى الذى انفجر فجأة بلا مقدمات عندما أطلق الشباب شراره التظاهر فى ميدان التحرير.
الثانى الاعتبارات الدولية المرتبطة بالمشروع الأمريكى الجديد لنشر الديمقراطية، من خلال أسلوب التدخل المباشر بالقوة الصلبة الذى اخفق فى العراق وأفغانستان، وكلفت أمريكا الكثير فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وأسلوب القوة الناعمة وفقاً لمنطلق الفوضى الخلاقة "نظرية كوندليزا رايس"، والحركات المدنية التى كتب منهج عملها الباحث الأمريكى جان شارب فى عدة كتب منذ السبعينات فى القرن الماضى، وأهمها كتاب " من الديكتاتورية للديمقراطية" الذى عرض فيه أساليب التظاهر والعصيان المدنى.
ولعبت قوتان رئيستان لتعزيز هذا المنهج وتهيئة المناخ له وهى جمعيات حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث الأمريكية خاصة تلك المتعلقة بنشر الديمقراطية وتقديمها الدعم المالى والسياسى والعلمى لمراكز الأبحاث العلمية ولجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى.
الثالث: الأيديولوجية العقائدية المرتبطة بمفهوم الخلافة الإسلامية والحكم الإسلامى وكلاهما له بريق شعبى وكلاهما غير محدد المعالم، وكلاهما مرتبط بالتحدى الخارجى، وكلاهما له هدف منظور ومعلن، هو العودة للأصول الإسلامية، وهدف غير منظور هو إلغاء مفهوم الوطنية وإلغاء الآخر، وفرض مفاهيم عفى عليها الزمن، ارتبطت بتاريخ الإسلام والمنطقة وظروف صراع المسلحين كقوة ناشئة مع القوى القائمة مثل مفهوم الردة والكفر وأهل الذمة ومكانة المرأة ونحو ذلك.
الرابع ضعف سلطة الحكم الانتقالى برئاسة المشير حسين طنطاوى والمجلس العسكرى الأعلى SCAF إزاء تهديدات القوى الإسلامية الإخوانية والسلفية وإزاء مناوراتهما التى تفوقت عليه فى وضع أولويات الفترة الانتقالية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل إصدار دستور للدولة يحدد كيفية تحقيق ذلك.
* باحث فى الدراسات الاستراتيجية الدولية.
د. نعمان جلال
استراتيجية السياسة الخارجية فى مواجهة التحديات الإقليمية والكونية
الجمعة، 21 مارس 2014 08:38 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة